Site blog
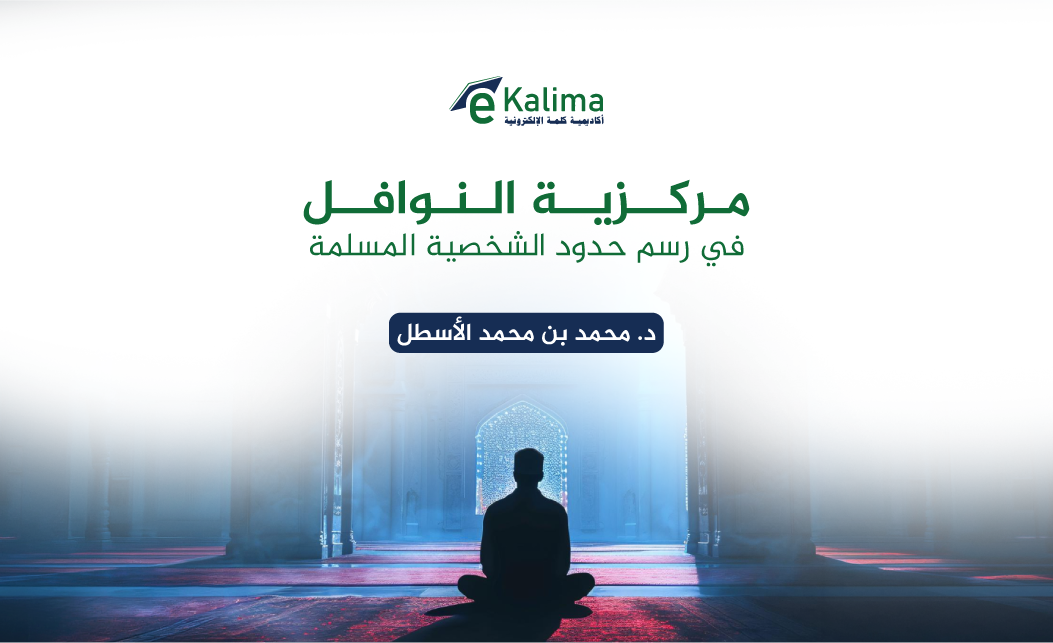
مركزية النوافل
في رسم حدود الشخصية المسلمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد:
فمما لا تخطئه العين في السلوك التربوي المعاصر التنظير بشكلٍ غير مقصودٍ لثقافة التزهيد في النوافل انطلاقًا من فقه الأولويات، والذي من بنوده أنَّ العلم أفضلُ من العلم، وأنَّ النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر.
وهذا ليس بجادةٍ من السبيل؛ وذلك لأنَّ الأفضلية الواردة في النصوص تعني زيادة الفاضل على المفضول مع اشتراكهما في أصل الفضل، فالكلام يتوجه لمزيد العناية بالفاضل لمن تيسر له الانتظام فيه وليس عن ترك المفضول، فحين نقول: إنَّ أوراد العلم خيرٌ من أوراد العبادة فلا يُراد أن يُقبِلَ الإنسان على أوراد العلم ويُدبر عن أوراد العبادة، ولا يكون الترك التام إلا في مواطن استثنائية حين يحصل التعارض التام بين الأمرين، وعندئذٍ يكون من الفقه في الدين أن تقدم ما قدَّم الله.
وسياسة الشريعة الجمعُ بين الأمرين مع تغليب الفاضل في العناية متى قامت أسبابه وتوفرت معطياته، وقد تصبح الأفضلية للمفضول في الأصل إذا كان الوقت له، أو قامت الحاجة له، وذلك أنَّ الأفضلَ في كلِّ وقتٍ وحالٍ هو إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال، والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه، ولابن القيم رحمه الله تقريرٌ نفيسٌ لهذا المعنى ختمت به كتاب "أنيس المتعبد" فانظره إذا شئت.
وفي هذه المقالة الموجزة أذكر خمسةً من المعالم الهادية التي تُبرز مركزية النوافل بما يعيدها في الأذهان إلى مرتبتها التي تستحق، وذلك كما يلي:
أولًا: النوافل طريقٌ إلى المقامات الفاضلة:
ومن أبرز الأدلة على ذلك: ما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ.."([1]).
فترتَّب حبُّ الله تعالى للعبد على النوافل؛ وذلك لأنَّ الفريضة قد يفعلها العبد توقيًا من غضب الله وعقابه فيما لو ترك، أما النوافل فهو يفعلها حبًّا لله فجوزي بحبِّ الله له.
ولك أن تتخيل أنك صليت الظهر فرضًا وسُنَّةً ثم نصبت قدميك وصلَّيت ركعتين أو أربعًا لا لشيءٍ إلا لحب الوقوف بين يدي الله تعالى، فالقيمة الإيمانية هنا لا تقاس بنوع الصلاة هل هي فرض أو نافلة؟؛ بل بتلك النفسية التي تقبل على الله تعالى وتحب الوقوف بين يديه وتعظِّم أمره وتأنس بشعائر عبادته.
فمن وصل إلى هذه المنطقة من التعامل مع الله علم أنه لا يعامل الله معاملة التاجر الذي لا يجود بشيءٍ إلا إذا عرف ما يُقابله من الربح؛ بل يعامل ربه معاملة المسافر حين يعامل صاحبه ويراه كل شيء، وفي الحديث عند مسلم: "اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ"([2]).
ومن هنا نفهم أحد أسرار عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالنوافل؛ فقد كان يقوم كل ليلة نصف الليل أو أقل من ذلك أو أكثر، ويجعل صلاته في ثماني ركعات لا تَسَلْ عن حُسنهن وطولهن، وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ولم يترك ذلك حتى فارق الدنيا، ولما تركه مرة قضاه في شوال، مع أن ليلة القدر توجد في رمضان دون غيره كما أنها في الليل دون النهار، وهذا إيذانٌ بأنَّ منافع التعبد أوسع بابًا من الأجر ولو عظُم.
وعلى ما تقرر فيمكن القول: إنَّ الفرائض تؤسس قاعدة العبودية أما النوافل فهي تتمم البنيان وتزينه.
ثانيًا: النوافل طريقٌ إلى الامتيازات الأخروية:
ومن أدلة ذلك: ما روى مسلم في صحيحه عن ربيعة بن كَعْبٍ الأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي: "سَلْ" فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ.
قَالَ: "أَوَغَيْرَ ذَلِكَ"؟
قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ.
قَالَ: "فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ"([3]).
وفي صحيح مسلم أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثوبان رضي الله عنه: "عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ؛ فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً"([4]).
وروى أبو داود والترمذي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا؛ فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا"([5]).
فهذه الدرجات العالية والامتيازات الفاخرة جعلها الله تعالى في حق المكثرين من النوافل.
وإذا ضممنا هذه النصوص وما على شاكلتها إلى المَعلم الفائت علمت أنَّ النوافل صنعة الكبار.
ومن أكثر الشواهد التي تفعل فعلها في نفسي قول الله سبحانه لنبيه وعبده زكريا عليه السلام: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ} [آل عمران: 41] بعد سياقٍ طويلٍ يأخذ بالألباب، فالله أجابه هنا في أمرِ سنةٍ خارقة، وحين وصَّاه لم يجعل الوصية على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحمل ثقال الأمور في ذات الله كما هو القريب من الأذهان؛ بل كانت الوصية بكثرة الذكر؛ إيذانًا بأنَّه من صنعة الكبار، وأنه يُبلِّغ صاحبه المنازل الرفيعة.
وقل مثل ذلك أو قريبًا منه في الآيات التي تناولت مريم عليها السلام بعد ذلك، {وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ (42) يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} [آل عمران: 42، 43].
ثالثًا: النوافل ترزق صاحبها الصفاء والنقاء والاتزان النفسي:
فكثرة الذكر وكثرة الركوع والسجود والتلاوة وما إلى ذلك لا يُنظر إليها على أنها مجردُ شعائر تعبدية؛ بل إنها تقطع عن صاحبها التشويش الإدراكي بما يُثمِرُ تهذيب النفس وراحة القلب وما يحتاجه من الصفاء والنقاء والاتزان النفسي في هذا العالم الصاخب.
وهذه ثمرةٌ عظيمةٌ بالغةُ النفعِ والأثر.
رابعًا: البصيرة والسداد في الأقوال والأفعال:
وهذه ثمرةٌ عن الاتزان النفسي؛ فإنَّ الإنسان يمارس القرارات صغيرها وكبيرها على مدار اليوم، والمكثر من النوافل أدنى من التوفيق وأقرب من السداد.
ومن الأدلة على ذلك: حديث البخاري الذي تقدم بعضه وفيه: "وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ"([6]).
وهذه ثمرةٌ عظيمة، فالذي يكثر من النوافل يحفظه ربه في أقواله وأفعاله وتوجهاته، فالكلام هنا عن بصيرةٍ معرفيةٍ وتوفيقٍ في اتخاذ القرار، وسداد في الحكم والفتوى والتقدير، وهذا واقعٌ ملموس.
خامسًا: قوة القلب والقدرة على مواجهة أعباء الحياة بجَلَد:
وبيان ذلك: أنَّ الذي يكثر من النوافل يعرف من أين تؤكل الكتف، ويرى من فضائل الله عليه ومن توفيقه ومن فَتحِ الله عليه في المعاني والمفاهيم ما يقوي مرجعيته الداخلية، وما يجعل لديه مركز ثقل داخلي لا يعرف للضعف أو اليأس سبيلًا، ويصبح أقوى عودًا وأعظم جلدًا في تحمل نوائب الحياة بعزمٍ وحزم.
إنَّ النوافل إذا جوَّدها صاحبها -وفي الطليعة منها قيام الليل- تقوي المناعة الداخلية بحيث يصبح على صلابةٍ لا يهتز بأدنى وارد كما لو آذاه أحدٌ في نفسه، فالاتصال بالقوي يقوي ويُثبِّت.
ومن هنا فإنَّ أي شخصٍ لا قدم له في التعبد لا بد وأن يصيبه التعب، وإذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهموم، وذلك حتى يدفع للعمل دفعًا، والمكابرة داءٌ لا دواء.
وحاصل القول: إنَّ النوافل تثبت وتقوي وتمنح السداد والبصيرة والصفاء والنقاء والاتزان النفسي والقوة في مواجهة أعباء الحياة، كما أنها طريقٌ إلى المقامات الفاضلة وإلى الامتيازات الكريمة في الآخرة.
وبما تقرر وتسطر يمكن أن نخلص إلى ما يلي:
- من أهمل أوراد التعبد لا بد وأن يعاني من قدرٍ من التعب.
- إنَّ أحوج الناس إلى الإكثار من النوافل من يتصدون لثغور الشأن العام من علمٍ ودعوةٍ وجهادٍ وسياسةٍ وغير ذلك؛ إذ إنَّ هؤلاء أحوج الناس إلى السداد والبصيرة وقوة القلب والجَلد والعزم والحزم والصفاء والنقاء فضلًا عن الخشية وقوة الديانة، وهذا الذي يفسر وفرة العناية بهذا الباب في حياة الأئمة كما تراه مثلًا في تراجم الأئمة الأربعة وغيرهم.
- إنَّ اختزال الشريعة في الفرائض هو تضخيمٌ للجانب القانوني من الدين، وليست الأحكام الشرعية إما واجبٌ وإما محرم، بل الواجب درجات والمحرم درجات، وبينهما السنة والمباح والمكره مع ما في كلِّ مرتبةٍ من درجات.
- ما تقرر في الفضائل يفسر لنا أحد أسرار اتساع الشريعة في التنظير للنوافل وترتيب الأجور عليها ليُقبل الناس عليها من تلقاء أنفسهم، وأحسب أن ترتيب الأجر الجزيل عليها يعني أن حجر الزاوية فيها هو في التربية على العناية بمحبوبات الله، وأن النفسية التي ترسمها النوافل حريٌّ أن يطلبها العبد ويحرص عليها ولو تعنى في ذلك.
- إنَّ النوافل لا تُؤَخَّر إلا إذا كانت على حساب غيرها لمن لم يتيسر له الجمع بين الأمرين، وذلك أنَّ المنهج الإسلامي يقوم على الجمع بين الفرائض والنوافل ما أمكن.
ولهذا كان من فقه الإمام أحمد بن حنبل قوله: "يعجبني أن يكون للرجل ركعاتٌ من الليل والنهار معلومة، فإذا نشط طوَّلها، وإذا لم ينشط خففها".
وهذا ما جاء به إفتاء الفقهاء؛ فهذا ابن قدامة المقدسي رحمه الله يقول: ويستحب أن يكون للإنسان تطوعاتٌ يداوم عليها فإذا فاتت فإنه يقضيها، وساق كلمة الإمام أحمد([7]).
وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ذلك فقال: واستحب الأئمة أن يكون للرجل عددٌ من الركعات يقوم بها من الليل لا يتركها، فإن نشط أطالها وإن كسل خففها، وإذا نام عنها صلى بدلها من النهار كما كان النبي r إذا نام عن صلاة الليل صلى في النهار اثنتي عشرة ركعة، وقال: "مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ"([8])([9]).
وفتح باب القضاء في النوافل فرعٌ عن مركزيتها كما هو ظاهر.
وبالنزول إلى الميدان فإنَّ فقه الرجل في هذا الباب يظهر في ثلاثة أمور:
- مدى قيامه بالثغور القائمة بحسب القدرة وواجب الوقت.
- وأخذه بما تيسر من النوافل التي يحقق بها العبودية لله والتي يستعين بها فيما يشتغل به من الثغور العامة.
- وفي قدرته على الموازنة بين الأعمال بحسب رتبها عند التزاحم والتعارض.
ومن عظم اشتغاله جدًّا فلا ينبغي أن ينحطَّ عن أمرين:
- الذكر الخاشع، وهي العبادة قليلة التكاليف عظيمة العوائد.
- صلاة ركعتين طويلتين خاشعتين، ولا ينبغي أن يخلو الأسبوع من ذلك، ومن ضاق وقته بكَّر يوم الجمعة جدًّا كأن يذهب إلى المسجد الساعة التاسعة ويطيل الصلاة.
وعلى كلٍّ فإنَّ الإنسان المشغول بحراسة ثغور الإسلام يلزمه أن يكون على بصيرةٍ في عبادة ربه، فالميزان الذي يزن به أقواله وأفعاله لا بد أن يكون شرعيًّا ليخدم الدين بموازين الدين، ولا يستثنى من ذلك كبار العلماء والمجاهدين والدعاة ومن على شاكلتهم؛ بل هؤلاء من أحوج الناس للنفس اللينة لتعظم الرحمة والخشية في قلوبهم، ويظهر حسن الخلق في تصرفاتهم وسلوكياتهم.
إنَّ كل يومٍ يمضي في حياتي أكتشف فيه مركزية النوافل في رسم حدود الشخصية المسلمة، وإني وإن عانيت التقصير في ذلك إلا أنه لا يمنعني أن أبوح بما خلصت إليه في هذا الباب.
وإذا كان الإنسان قريبًا من رمضان فلديه فرصةٌ عظيمة في الاستدراك والانطلاق؛ وذلك أنَّ النفوس تقبل على النوافل فيه بغير كبير جهدٍ أو عناء لأسباب ذكرتها في أوائل كتاب "أنيس المتعبد"، مما يسهل معه إعادة ضبط البوصلة وتثبيت بعض العادات، وأكثر الناس اليوم يعانون من قدرٍ من الغفلة والتشتت والذهول، فيأتي رمضان يرد الإنسان إلى الجادة، وما يجده من لذائذ الطاعة عبر جرعات مركزة على مدار ثلاثين يومًا ييسر له تثبيت قدمه في محراب التعبد ليبدأ العهد الطيب مع الله بعد أن طالت عن الله غيبته وطالت غربته وفقدته المحاريب وأوراد الغداة والعشي قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.
والله الموفق وهو المستعان وحده، والحمد لله رب العالمين.
وكتبه: محمد بن محمد الأسطل.
تحريرًا في يوم الثلاثاء 22-8-1447 هـ الموافق 10-2-2026م.

بصيرة حول النظام السياسي في الإسلام
د.عبدالكريم بكار
الاقتتال الذي حدث بين الصحابة الكرام في زمان الخلفاء الراشدين يدل على أحد أمرين:
الأول أنهم كانوا يعلمون أن هناك نظاما سياسيا يجب تطبيقه والاحتكام إليه ولكنهم لم يفعلوا اتباعا لهوى أو شهوة وهذا بعيد جدا لأنهم أبر الأمة قلوبا وأكثر الناس فهما عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.
الاحتمال الثاني أنهم لم يعثروا فيما فقهوه على نظام سياسي مبلور بالقدر الكافي وهذا أحوجهم الى الاجتهاد ومع الاجتهاد وقع الخلاف والاقتتال.
وهذا الاحتمال هو الأقوى والأرجح.
الشارع الحكيم وضع مبادئ وقيما عليا تجب مراعاتها و خدمتها في أي نظام سياسي وهي قليلة مثل الشورى والعدل والنزاهة وعدم استغلال السلطة وبذل أقصى الجهد في خدمة المصلحة العامة.
خدمة هذه المبادئ تحتاج إلى نظم عدة من أهمها النظام السياسي والنظام الإداري.
النظام هو عبارة عن شبكة من الأساليب والوسائل والإجراءات والتقنيات واللوائح التنظيمية وهذا يعني أنه مؤقت ومتطور ومتفاعل مع الواقع وهذا يعني أن الوحي لم يبلور للمسلمين نظاما للحكم لأنه لو حوّل ما شأنه التغير إلى شيء ثابت لأوقع الناس في حرج عظيم.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أعظم رجل استراتيجية في تاريخ المسلمين وقد حاول إنشاء نظام سياسي يخدم المبادئ التي أشرنا إليها وقام بأعمال عبقرية فعلا لكن ماذابقي اليوم من نظم عمر؟
نحن اليوم نتحدث عن القيم العظمي التي تمثلت في حكم عمر ولكننا نجد أنفسنا محتاجين إلى نظم أكثر تعقيدا وإحكاما وتطورا من تلك التي أرساها عمر وهذا ينطلق من سنة ربانية هي عدم اتساع مرحلة سابقة لمرحلة لاحقة.
السؤال اليوم هو هل ما يعاني منه المسلمون يكمن في عدم الالتزام بالمبادئ التي التزم بها عمر أو في عدم تطبيق الإجراءات التنظيمية التي اتبعها عمر؟
لاشك أن المشكلة في معاناة المسلمين اليوم هي في البعد عن القيم والمبادئ التي التزم بها عمر والزم بها أركان دولته
الخلاصة: المطلوب اليوم بلورة أو اقتباس نظم تحوّل المبادئ من كلام وعظي إنشائي إلى واقع يعيشه الناس ويحميه القانون ويدافع عنه المجتمع.
هذه قناعتي وقد أكون مخطئا لكنني لم أقل بحمد الله إلا ما أعتقد أنه الصواب والله الهادي إلى سواء السبيل.
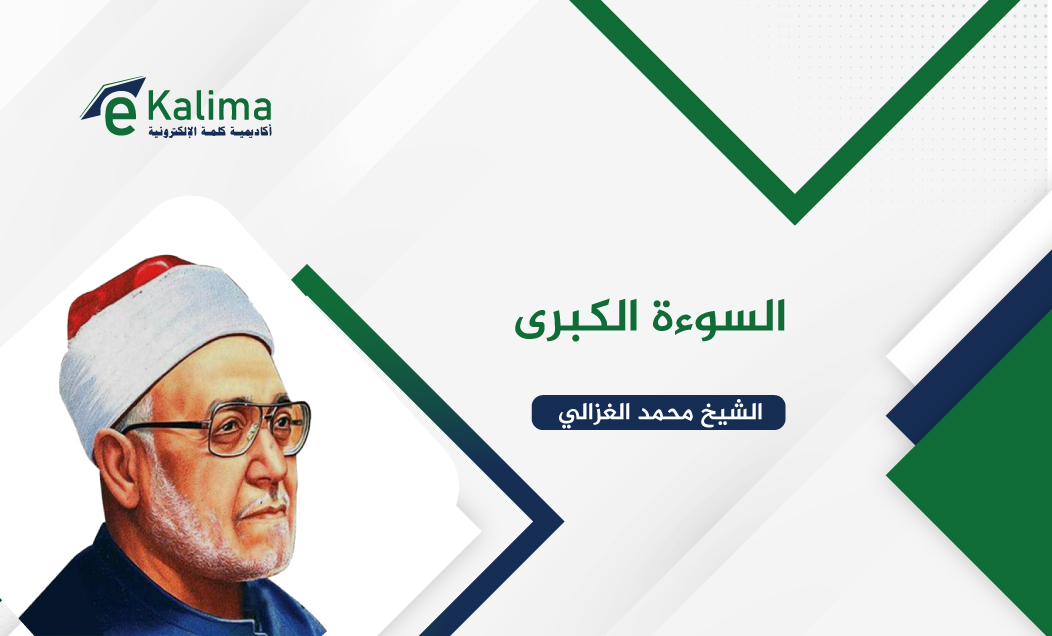
السوأة الكبرى
محمد الغزالي
الطبيعة البشرية واحدة فى القارات المزدحمة بسكانها، وعلى امتداد الأمس واليوم والغد، والناس يذوقون آثار هذه الطبيعة حلوها ومرها، وقلما تختلف أحكامهم عليها، فالظلم مستقبح، والعدل مستحسن، والدناءة عيب والشرف محمدة.
ومع ذلك فإن الذين يحبون العوج ويكرهون الاستقامة كثيرون وبلغ من كثرتهم أن ذلك كاد يعد طبعا للناس، فإن طغيان الظلمة سود تاريخ العالم.
وفى ذلك يقول المتنبى:
صحب الناس قبلنا ذا الزمانا .. وعناهم من أمره ما عنانا
ثم يقول: كلما أنبت الزمان قناة .. ركب المرء للقناة سنانا
[ارتكاب الجرائم بين الصور الصغرى والكبرى]
والواقع أنه وجد كثيرون لا يرون حرجا من السطو على كدح العاملين واقتناصه سُحتًا، وكثيرون يرون راحتهم فى الخلاص من خصومهم، والإجهاز على حياتهم، وكثيرون يرون لذة المخالسة فى الاستيلاء على عرض حرام أولى من الارتباط به عن طريق الحلال الحلو والبارد العذب..
والغريب أن الصور الجزئية لهذه الجرائم يمكن أن تضبط وتحاسب، أما الصور الكبرى فإن الإفلات فيها بالغنائم الحرام ميسور وشائع، وقد قرأت لأحد الصحافيين هذه الكلمات: “اللصوص يسرقون ويهربون، بعضهم يدركه العقاب، والآخرون يفرون بما سرقوا ونهبوا دون أن يمسهم أذى! فالذى يسرق الرغيف يدخل السجن، والذى يسرق الفرن لا يدخل السجن! لأن سارق الرغيف لص ضعيف، أما سارق الفرن فهو لص قادر يتعاون مع عصابات قادرة، ويجد من الأموال التى سرقها ما يقدره على تدويخ العدالة، فهو يوكل أحسن المحامين عنه، وبين براعة الدفاع وعناء القضاء تذهب الحقيقة”.
وإفلات مجرمين من يد العدالة غير مستغرب، ولكن المستغرب وجود لصوص من طراز آخر، لصوص شرفاء جدا، لا يُتهمون، ولا يُقدمون للعدالة أبدا، لصوص لهم مناصب مهيبة وألقاب طنانة وكلمات نافذة..!! سرقوا شعوبهم جهرة، ونمت لهم ثروات طائلة، واحتبست الألسن فى الحلوق فما تقدر أن توجه لهم لفظا!!
والسرقات من هذا النوع تجىء عرضا، أو تجىء تابعة للاستيلاء على السلطة، والاستمكان من مقاليد الأمور، واغتصاب الحكم لشهوة عارمة شىء غير تولي الحكم باسم الله ورضا الأمة، الأول فجور والثانى تقوى.
[الأتقياء في التاريخ السياسي ندرة]
ويظهر أن الأتقياء فى التاريخ السياسى للأمم كانوا أندر من الماء فى الصحراء، وإن الذين غلبوا على مصاير الأعم كانوا قطاع طريق مهرة فى سرقة الأمجاد والكفايات، وبناء الجاه والسطوة والأبهة على أنقاض المستذلين والضائعين! وقد حكى القرآن أن واحدا من أولئك الفراعنة جادل إبراهيم فى ربه، وزعم أنه له سلطانا يضارع سلطان الله فى أرضه؛ أليس قادرا أن يعدم من يشاء ويستبقى من يشاء؟؟
كان المألوف فى سلطات هؤلاء الحكام أن يعلن أحدهم الحرب، ويسوق إلى ميدانها الألوف المؤلفة من الناس كى يحققوا له مجدا ويكتبوا بدمائهم سجل عظمته، وكان المألوف أن تجبى ثمرات الأرض لشخصه الكريم ضرائب مباشرة وغير مباشرة لتلبى أولا حاجاته وحاجات أتباعه، ثم يرمى الفتات الباقى للمصالح العامة.
وقد سبقتنا أوروبا إلى تقليم أظافر حكامها، فقتلت بعضهم فى ثورات حانقة، ووضعت دساتير دقيقة لضبط مسالك الباقين، حتى صار الحكم هناك خدمة عامة يختار لها الأكفأ، ويراقب من خلال أجهزة يقظة، ويُطرد ولا كرامة إن بدا منه ما يريب.
أما الشرق الإسلامى فإن الفساد السياسي بقى فى أغلب ربوعه حتى القرن الرابع عشر للهجرة، إنه متأخر بضعة قرون فى طريق التقدم العالمى، ولا يزال اكتساب الحكم فيه سهلا، ولا يزال الحكم وتملق الحاكمين أخصر طريق للمال والجاه، وما يثير الدهشة هو الفرق الكبير بين تعاليم الإسلام وأحوال المسلمين.
[المشتغلون بالعلوم الدينية والسوأة الكبرى]
وما يثير الدهشة أكثر وأكثر هو موقف المشتغلين بالعلوم الدينية وفقه الشريعة.. كأن هؤلاء كونوا بطريقة خاصة ليكونوا حواشى للحاكمين! لقد فزعت وأنا أرى كبيرا منهم يصفق بيديه ـ مثل صبى طائش ـ تكريما أو إرضاء لأحد الحكام! إننى أعلم أنه من أجل ذلك اختير! لكن الهبوط ما ينبغى أن يبلغ هذا الدرك ولو لحماية المظاهر. والسقوط الخلقى آفة بعض رجال الدين، ولكنى أظن ذلك سببا ثانيا لفساد الحكم فى العالم الإسلامى. إن السبب الأول هو خلل التفكير الفقهى عند الجم الغفير من المتكلمين فى الفقه!
سمعت جدالا بين أناس يتحدثون عن حكم لمس المرأة ولمس إحدى السوأتين، والأقوال المتضاربة في هذه القضية!
فقلت لهم: هذه أحكام تُقرّر في خفوت، ويُذكر الخلاف فيها بكثير من التجاوز، وأمرها لا يستحق هذا الحماس ولا ذلك العناد!
فنظروا إلىّ مستنكرين! فقلت لكبيرهم: أتعرف شيئا عن السوءة الكبرى في الإسلام؟ وجاء الرد بسرعة، أي سوءة؟
قلت: ضياع الإسلام فى الأندلس وذهاب ريحه وانتهاء دولته ومحو حضارته!
هل درستم أسباب ذلك، وأخذتم الحيطة حتى لا تتكرر المأساة؟
إننى أدهش عندما يجيئنى متقعر يسألنى: هل يقضى المأموم الركعة إذا لم يقرأ الفاتحة ولكنه أدرك الإمام راكعا؟
لقد قلت لهذا السائل: الجمهور على أنه لا يقضي!
فقال بسماجة: لا، يجب أن يقضي والسنة الصحيحة توجب ذلك! قلت له: ما دام يؤثر الرأي الآخر فليقض الركعة!
فأراد أن ينشئ معركة علمية في هذه القضية.
فقلت له بصبر نافد: إن تعلقكم بهذه الخلافات لا مساغ له! أريد أن أسألك: التناصر بين المسلمين واجب، فكيف ينصر المسلم فى إفريقية أخاه في آسيا، هل فكرتم في ذلك، واكتشفتم وسيلة مادية أو أدبية؟
إن الحكومات تعالج شئونا عادية وعبادية خطيرة، فهل فكرتم فى طريقة لنصحها، وعرض وجوه الرأي عليها، وإلزامها بالحق إن هي رفضته،
وتأمين معارضيها إذا فكر مستبد فى إيذائهم.
إن تخلف المسلمين شائن في دنيا الناس فهل فكرتم في أسلوب يكشف عنهم هذا العار؟
حتى إذا تقدموا صناعيا وحضاريا أمكنهم أن يدفعوا عن عقائدهم، ويحموا مساجدهم من نظم تريد إغلاقها، ومنع اسم الله أن يذكر فيها؟
فقال لى المتفقه المغفل: هذه سياسة وأنا أكلمك في الفقه!.
قلت: أنا أكلمك في الفقه، وأنت وأمثالك صرعى سياسات محقورة شغلت الجماهير بالخلافات الصغيرة حتى يمضى الفجار في طريقهم دون عقبات..
إن الاستبداد السياسى استطاع على تراخى الأيام أن يحذف أبوابا مهمة من قسم “المعاملات” في فقهنا الضخم! أو أن يجعل حقائقها ضامرة مهزولة لأن الكلام فيها مرهوب النتائج.
ومن ثم طال الحديث في أمور هينة وكثرت فيها التفريعات والأخيلة البعيدة، على حين صمت الفقه في الأمور الجلل.
وتم البت في قضايا المسلمين العظمى بين جماعات من الفُتاك يذكرون أنفسهم وأتباعهم كثيرا ولا يذكرون الله إلا قليلا..
وقد وقعت فواجع في بيئات الحكم يندى لها الجبين، وأهيل عليها التراب دون تعليق، ففى اليمن قتل أمير ـ أو تآمر على قتل ـ تسعة من إخوته حتى تخلص إمامة المسلمين للأخ القاتل وحده!!
ومطلوب من الفقه الإسلامى أن يشغل بمكان وضع اليدين فى الصلاة! أو برفعهما قبل الركوع! وهي أحكام تتساوى فيها وجهات النظر، ولا يأثم مسلم يجنح فيها إلى السلب أو الإيجاب..
نعم مطلوب منه إفاضة الكلام فى هذه القضايا وتكوين عصابات من الرعاع تشغل المصلين بهذه الأحكام، وتثير بينهم الفتن!! أما سياسة الحكم والمال فعلاقة الفقه بها مقطوعة، وحسب نفر من العلماء المعاصرين أن يرددوا فيها أقوالا سقيمة، قررها الجبناء الهاربون أو المفكرون القاصرون..
كانت النتيجة المريرة أن حكَم المسلمين رجالٌ لا يؤمَنون على شيء، ولا تحركهم إلا غرائز طفولية من جنون العظمة والاستئثار بالسلطة..
ولم تكن القوة المعادية للإسلام غافلة! ومتى غفلت؟ إنها بين الحين والحين تنفذ من هذه الثغرة في مجتمعنا لتهلك الحرث والنسل، وهي تفعل ذلك بأيدينا نحن لا بيد زيد أو عمرو!
ومن أعصار طويلة وهذه الفوضى الفكرية تسود العالم الإسلامى وتعوج بخطاه عن بر هدف شريف فإذا قضايا كبيرة تموت مكانها لا يكترث بها أحد،
وإذا أمور توافه يهيج لها الخاصة والعامة!
[سنة الله تمضي]
ومضت سنة الله فى أمتنا كما مضت في كل مجتمع مختل، فتدحرجنا من مكان الصدارة إلى ذنب القافلة الإنسانية، وأسأنا إلى ديننا بقدر ما أسأنا إلى أنفسنا..
وجاءت ساعات الصحو والمحاسبة وتأنيب الضمير! وبدأنا نغضب لما أصابنا ونأسف لما ضاع منا، فكيف العمل؟
البعض يريد السير في ذات الطريق الذى انتهى به إلى الذل..
البعض يرفض بكبر غريب أن يعرف لماذا تقدم غيرنا..
البعض يعجز عن فهم الفطرة الإنسانية ويظن الدين حربا عليها!
(*) من كتاب كتاب الفساد السياسي.

دقائق الليل الغالية
د. محمد أحمد الراشد
سجود المحراب ، واستغفار الأسحار ، ودموع المناجاة, وقيام دقائق الليل الغالية : سيماء يحتكرها المؤمنون .
ولئن توهم الدنيوي جناته في الدينار ، والنساء ، والقصر المنيف ، فإن :
جنة المؤمن في محرابه (1)
ولقد منَّ الله على الناس بكثير من المباح الحلال يفند الرهبانية ، ولكن المؤمن له لذة كلما توجه إلى ربه بصفاء روح ، تتضاءل بجانبها لذة المباح ، فيهجر الكثير منه حذراً من كدر يعكر الصفاء الذي هو فيه .
جرب ذلك المؤمنون قديماً ، زمن العيش البسيط ، وجربه المؤمنون اليوم ، زمن المدنية المعقدة .
بل إن الصلاة في يوم هذه المدينة لأظهر في إضفائها السرور ، فبينما يطيل التعقيد على الإنسان حياته الحاضرة ، فيسأم ، ويمل ، و يضجر ، تختصرها الصلاة إلى بضع ساعات فحسب ، فيعيش في اطمئنان ، وراحة بال ، ولئن كان لنظرية آينشتاين في نسبية الوقت نصيب من الصحة ، فإن في الصلاة هذا النصيب ، كما يشرحه مصطفى صادق الرفاعي و يقول :
” يا لها حكمة أن فرض الله علينا هذه الصلوات بين ساعات وساعات ، لتبقى الروح أبداً إما متصلة أو مهيأة لتتصل ، ولن يعجز أضعف الناس مع روح الدين أن يملك نفسه أنه متوجه بعدها إلى ربه ، فخاف أن يقف بين يديه مخطئاً أو آثماً ، ثم هو إذا ملك نفسه إلى هذه الفريضة ذكر أن بعدها الفريضة الأخرى ، وأنها بضع ساعات كذلك، فلا يزال من عزيمة النفس و طهارتها في عمر على صيغة واحدة لا يتبدل ولا يتغير ، كأنه بجملته – مهما طال – عمل بضع ساعات “(2)
فطول الحياة نسبي.
هو طويل جداّ ، مخيف مظلم للجاهلي.
وهو قصير ، هين منير للمصلي.
وحياة الجاهلي ركود مستمر.
وحياة المصلي حركة ، تزيد صواباً ، أو تستدرك اعوجاجاً .
وإنها ( الله أكبر ) تنهي هذا الركود ، وتؤسس الحركة ( الله أكبر ) .
بين ساعات وساعات من اليوم ترسل الحياة في هذه الكلمة نداءها تهتف :
” أيها المؤمن : إن كنت أصبت في الساعات التي مضت ، فاجتهد للساعات التي تتلو . وإن كنت أخطأت فكفّر ، وامح ساعة بساعة “(3)
وأظهر حركة يولدها التكبير : حركة التمييز والفرقان ، بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان .
فإنك إن قلت : { اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين }.
استشعرت في كل ركعة طائفة من هذه الأصناف الثلاثة ، وتخصص كل ركعة لمن ظهر منهم في زمن واحد ، أو بلد واحد ، فتجول في ركعات يومك بلاد الإسلام أجمع، وتستعرض تاريخ الإسلام أجمع .
ففي ركعة تذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الأطهار رضي الله عنهم مثلاً لمن أنعم الله عليهم ، وتذكر أبا جهل ومسيلمة مثلاً للمغضوب عليهم والضالين .
وفي ركعة أخرى تذكر هوداً وصالحاً – عليهم السلام – مثلاً ممن أنعم الله عليهم ، وعاداً وثمود من الهالكين .
وفي ركعة أخرى تذكر الحسن البصري وابن سيرين و ابن المسيب ممن أنعم الله عليهم ، وأهل الردة ، والجهم بن صفوان ، والجعد بن درهم من المتخبطين .
وفي أخرى تذكر ابن تيمية وابن القيم وابن الجوزي من المصلحين ، وأصحاب وحدة الوجود والفناء الموهوم و الشطح والابتداع من المدلسين .
وفي أخرى تذكر الإمام البنا وعودة وسيد ، وثباتهم أمام الطغاة المتجبرين .
وبذلك تعقل صلاتك ، والمرء ليس له من صلاته إلا ما عقل منها ، و تجدد عهدك مع أجيال المؤمنين ، وتنبذ المفسدين ، وتلك هي حركة الإيمان ، فإن الإيمان الحق ما أخذ منك الولاء ، وتركك على المفاصلة .
رجال مدرسة الليل
ولكن تمام التذكر يكون مع الهدوء والسكون .
فمن ثم كانت مدرسة الليل .
وكان ترغيب الله للمؤمنين أن يجددوا سمت الذين {كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون * وبالأسحار هم يستغفرون}
وإذا انتصف الليل ، في القرون الأولى ، كانت أصوات المؤذنين ترتفع تنادي :
يارجال الليل جدوا
رب صوت لا يرد
ما يقوم الليل إلا
من له عزم وجِدُّ
وإنها حقاً لمدرسة ، فيها وحدها يستطيع رجالها أن يذكوا شعلة حماستهم ، وينشروا النور في الأرجاء التي لفتها ظلمات الجاهلية .
وإنها تجربة إقبال يوجزها فيقول :
نائح والليل ساج سادل
يهجع الناس ودمعي هاطل
تصطلي روحي بحزن وألم
ورد ( يا قوم ) أنسي في الظلم
أنا كالشمع دموعي غسلي
في ظلام الليل أذكي شعلي
محفل الناس بنوري يشرق
أنشر النور ونفسي أحرق (4)
وإن دعوة الإسلام اليوم لا تعتلي حتى يذكي دعاتها شعلهم بليل ، ولا تشرق أنوارها فتبدد ظلمات جاهلية القرن العشرين مالم تلهج بـ( يا قيوم ) .
ما نقول هذا أول مرة ، وإنما هي وصية الإمام البنا حين خاطب الدعاة فقال:
” دقائق الليل غالية ، فلا ترخصوها بالغفلة “ (5)
أفعيينا أن نعيد السمت الأول ، أم غرنا اجتهاد في التساهل و التسيب و الكسل جديد ؟
إن القول لدى الله لا يبدل ، ولكنا أرخصنا الدقائق الغالية بالغفلة ، فثقل المغرم ولم يجعل الله لنا من أمرنا يسراً .
إن انتصار الدعوة لا يكمن في كثرة الرق المنشور ، بل برجعة نصوح إلى العرف الأول ، ومتى ما صفت القلوب بتوبة ، و وعت هذا الكلام أذن واعية : كانت تحلة الورطة الحاضرة التي سببتها الغفلة المتواصلة .
ذلك شرط لا بد منه .
وكأن النصر حجب عنا لأننا نادينا من وراء الحجرات ، وجهرنا رافعين أصواتنا نوجب على الله لنا هذا النصر بادلال ، نبيعه و نثبت لنا حقاً عاجلاً في الثمن من دون أن نقدم بين يدي بيعنا همساً في الأسحار ، ولا الدمع المدرار ، وإنما النصر هبة محضة ، يقر الله بها عين من يشاء من رجال مدرسة الليل في الحياة الدنيا ، ولا يلت الآخرين المحصرين من ثمنهم في الآخرة شيئاً ، ويوقع أجرهم عليه .
إن تعلم الإخلاص ، وفضح الأمل الكاذب الدنيوي أجلى أعطيات مدرسة الليل ، كما يقول وليد ، وذلك ما توجب تربيتنا تركيزه وتعميقه في النفوس .قال ، والحق ما قال :
ياليل قيامك مدرسة
فيها القرآن يدرسني
معنى الإخلاص فألزمه
نهجاً بالجنة يجلسني
ويبصرني كيف الدنيا
بالأمل الكاذب تغمسني
مثل الحرباء تلونها
بالإثم تحاول تطمسنى
فأباعدها و أعاندها
وأراقبها تتهجسني
فأشد القلب بخالقه
والذكر الدائم يحرسني (6)
وأكثر من هذا فإن من يتخرج في مدرسة الليل يؤثر في الأجيال التي بعده إلى ما شاء الله ، والمتخلف عنها يابس قاس تقسو قلوب الناظرين إليه، والدليل عند بشر بن الحارث الحافي منذ القديم ، شاهده وأرشدك إليه, فقال :
” بحسبك أن قوماً موتى تحيا القلوب بذكرهم ، وأن قوماً أحياء تقسو القلوب برؤيتهم ” .
فلم كان ذلك أن لم يكن ليل الأولين يقظة ، وليل غيرهم نوماً ؟ ونهار الأولين جداً ، ونهار الآخرين شهوة
أتسبقك الحمامة ؟
وإنه لقلب رقيق قلب الفقيه الزاهد أبي سهل الصعلوكي ، يظهره تأنيبه لنفسه في قوله :
أنام على سهو و تبكي الحمائم
وليس لها جرم ومني الجرائم
كذبت لعمرو الله لو كنت عاقلاً
لما سبقتني بالبكاء الحمائم (7)
فإن الذنب لا يغسل إلا بدمع ، والشجاعة تسقى بدموع الليل ، وما عرف تاريخ الإسلام رجاله إلا كذلك ، ولم يقل ابن القيم باطلاً في وصفه لهم بأنهم :
يحيون ليلهم بطاعة ربهم
بتلاوة ، وتضرع و سؤال
وعيونهم تجري بفيض دموعهم
مثل انهمال الوابل الهطال
في الليل رهبان ، وعند جهادهم
لعدوهم من أشجع الأبطال
بوجوههم أثر السجود لربهم
وبها أشعة نوره المتلالي (8)
وسَأَلَ عبد الوهاب عزام الليلَ عن أروع أسراره ، فأبان جوابه عن إصابة المؤمنين والمذنبين في تحريهم إياه واستمع لتحاورهما:
قلت لليل: كم بصدرك سر
أنبئني ما أروع الأسرار ؟
قال: ما ضاء في ظلامي سر
كدموع المنيب في الأسحار(9)
أفترى المؤمنين إلا مصدق بجواب الليل ، فهو مسارع مستبق ؟
أم ترى أهل البلاغة إلا في إذاعة لما قال ؟ يستملون الناس :
فاز من سبح والناس هجوع
يدفن الرغبة ما بين الضلوع
ويغشيه سكون وخشوع
ذاكراً لله والدمع هموع
سوف يغدو ذلك الدمع شموع
لتضيء الدرب يوم المحشر
سجدة لله عند السَحَر(10)
ويلقنون المذنبين المخطئين طريق الجنة ، فيستملون المسرف في أخرى أن :
عد إلى الله بقلب خاشع
وادعه ليلاً بطرف دامع
يتولاك بعفو واسع
ويبدل كل تلك السيئات
حسنات أجرها لن ينفدا
كل هذا العفو للعبد المنيب
سابغا من خالق الكون الرحيب
للذي تاب إليه من قريب (11)

{ یُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ بِٱلۡقَوۡلِ ٱلثَّابِتِ فِی ٱلۡحَیَوٰةِ ٱلدُّنۡیَا وَفِی ٱلۡـَٔاخِرَةِۖ وَیُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّـٰلِمِینَۚ وَیَفۡعَلُ ٱللَّهُ مَا یَشَاۤءُ }
[سُورَةُ إِبۡرَاهِيمَ: ٢٧]
تهب الرياح العاتية فتقتلع وتحطم من ليس له جذور راسخة؛
لنستطلع مشاهد مما يفعله إعصار متوسط القوة بمدينة عامرة بالمباني والسكان:
يا له من ركام تختلط فيه السيارات بالمباني والأشخاص وكل ما حملت السيول،
كل ما نراه في ذلك الركام كان ثابتا في مكانه قبل الإعصار أو هكذا كان يظن، فجاء الإعصار فأظهر الحقيقة،
حمل السيل ما خف وما ثقل فلم ينج سوى ما ثبتت جذوره وصح بناؤه،
وكذلك تختبر المبادئ حين تعصف بنا الأحداث ويجتاح الطوفان.
في الرواية أن سدا عظيما بقي متماسكا وثبت في مكانه أزمانا ولكن الملل أصاب حجرا واحدا من أحجاره فقرر مغادرة مكانه فكان سيل العرم،
إن بقاء البناء لا يستوجب ثباتا فرديا فقط بل هو نسيج المجموع كما علمنا قائدنا ونبينا عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا،
فليس من الحكمة أن نتصدى للعاصفة وقوفا حاسرين بل يحسن فيها الكمون والحذر والشد على يد إخوانك،
إن كان ابتلاء أهل فلسطين في أنفسهم عظيما فابتلاؤنا أيضا في ديننا عظيم والله ناظر ما نفعل.
في هذا الطوفان يتوجب علينا أن نتمسك جيدا بالمبادئ ونستحضر كل أسباب الوحدة ونبذ الفرقة والتنبه لمكائد العدو وليس أقلها الضخ الإعلامي والاختراق الأمني، انظر ما تقول وما تفعل هل يرضي الله ويأتي بعونه أم غير ذلك، إن التنازع فشل وحظ النفوس فشل ووحدة الصف والهدف طريق النجاة ووصفة النجاح،
إن الثبات يحتاج الى صلة متينه بالله على نهج نبيه، وتعهد وتدبر للقرآن، والتكاتف والتآزر والتماسك الأخوي حيث ينصر بعضنا بعضا وينصح بعضنا بعضا.
لنقف مليا مع قصة طالوت وما فيها من دروس وعبر عديدة؛ بدأت بالتشكيك في اختيار النبي لطالوت ثم تخاذل وعصيان متكرر وتصفية أفضت إلى فئة صابرة ثابتة واثقة بربها ومنهجها:
{ وَلَمَّا بَرَزُوا۟ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦ قَالُوا۟ رَبَّنَاۤ أَفۡرِغۡ عَلَیۡنَا صَبۡرࣰا وَثَبِّتۡ أَقۡدَامَنَا وَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَـٰفِرِینَ }
[سُورَةُ البَقَرَةِ: ٢٥٠]
وفي جوهر القصة بيان لمنهج طالوت في صنع تلك الفئة أن: اترك ما تشتهي واصبر على ما تكره، وبذلك يعظم في القلوب أمر الله وتهون الصعاب.
احفظ قلبك واحفظ لسانك واحفظ فكرك، فالطوفان انطلق وأمواجه كالجبال ولن يتوقف بأمانينا بل نصلح سفننا ونشد اشرعتنا حتى يأذن الله بالنصر والفتح.

قال علي كرم الله وجهه لكميل بن زياد: يا كميل، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق. وقد شرح ابن القيم هذه الكلمات ـ المقتبسة من مشكاة النبوة ـ شرحا مستفيضا في "مفتاح دار السعادة".
وقال أبو الأسود: ليس شيء أعز من العلم، الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك! وهذا ما عبر عنه الشاعر فقال:
إن الأكابر يحكمون على الورى وعلى الأكابر يحكم العلماء!
وسئل ابن المبارك: من الناس؟ فقال: العلماء، قيل: فمن الملوك؟ قال: الزهاد. قيل: فمن السفلة؟ قال: الذين يأكلون الدنيا بالدين! وإنما لم يجعل غير العالم من الناس، لأن الخاصية التي يتميز بها الإنسان عن البهيمة هي العقل، وهو إنما يظهر بالعلم.
وقال ابن عباس: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها!
وقال الحسن: يوزن مداد العلماء بدماء الشهداء، فيرجح مداد العلماء.
وقال في تفسير قوله تعالى: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة) إن الحسنة في الدنيا هي العلم والعبادة، وفي الآخرة هي الجنة.
وقيل لحكيم: أي الأشياء تقتني؟ قال: الأشياء التي إذا غرقت سفينتك سبحت معك! يعني: العلم.
وقال الإمام أحمد: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، لأن المرء يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد الأنفاس.
وقال بعض السلف: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم.
.....
- المصدر: "الحياة الربانية والعلم" لسماحة الشيخ.

أسّس القرآن لمبدأ حضاري عظيم هو أنه لاينبغي أن يكون في المجتمع الإسلامي أي شخص فوق المساءلة حتى لايتحول إلى مصدر لحماية الفاسدين والمقصرين وهذا واضح من خلال عتاب القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم على بعض اجتهاداته على ماهو مشهور في العديد من الآيات القرآنية.
إن النقد الذاتي يشكل مرتكزاً من أهم مرتكزات أي نهضة لأي أمة وهو
يشكل حجر الزاوية في الحضارة الغربية.
لدينا أسئلة محرجة تجعلنا نحدّق في المرآة لنرى أنفسنا وسلوكياتنا على ما هي عليه.
إثارة الأسئلة الصعبة جارحة والإجابة عنها أيضاً جارحة لكن آلامها تظل أخف من آلام استمرار مآسي الإهانة والظلم والاستبداد والعوز التي يعاني منها مئات الملايين من المسلمين في أنحاء المعمورة.
1- كيف استطاع مهاجرون مختلفو الثقافات والأديان وبعضهم أشبه بحثالات من تشييد دولة قوية جدا وجذابة للعيش لكل أبناء أمم الأرض كما هو الشأن في الولايات المتحدة الأمريكية ؟
وكيف استطاع الصهاينة إقامة دولة في فلسطين من خلال استقدام ملايين اليهود من 126 دولة.
دولة مزدهرة ومستقرة ومحتلة لأراضي دول كبيرة حولها.
دولة لم تشهد عبر أكثر من 60 سنة سوى اغتيال سياسي واحد!
الهند ذات الملل والنحل واللغات وأكثر من ألف مليون من بني آدم دولة مستقرة ومزدهرة أكثر بكثير من جيرانها المسلمين الذين تعصف بهم الحروب والتصفيات الكيدية ويلفها الفساد من الرأس إلى أخمص القدم!
لماذا صارت الفرقة والتشتت والتخوين والاقتتال الداخلي والنزاع حول صغائر الأمور من اختصاص العرب والمسلمين مع أننا نفخر باسم أهل السنة والجماعة ؟!
2- لماذا معظم المسلمين اليوم فقراء ومحتاجون ومستهلكون لما ينتجه غيرهم مما يجعلهم يعيشون على هامش العالم في كل مجال من مجالات الحياة ؟!
3- لماذا نحن خلف الأمم في معظم مؤشرات التحضر : التعليم والبحث العلمي والصحة والصناعة والتقنية والخدمات والضمان الاجتماعي ؟!
4- لماذا ينتشر بيننا الكذب والفساد المالي والإداري والرشوة وأكل حقوق العمال والمستضعفين إلى جانب المجاملة والمداهنة على حساب العقيدة والمبدأ؟!
5- لماذا نحن مشدودون إلى الماضي ونقيم المعارك الحامية حول تفسير أحداثه والدفاع عن تصرفات رجالاته مع أن الله تعبدنا بالمنهج الرباني الواضح والشامل وليس بالسوابق التاريخية ؟!
سأكتفي بهذه التساؤلات لأقول في الجواب عن كل هذا : إن هناك من سيقول فورا : السبب هو عدم التزامنا بديننا ومكائد الأعداء لنا.
هذا ولا شك صحيح ولكن لماذا لم نلتزم بأمور ديننا رغم مر الشكوى من الجميع و السؤال الآخر هو :ما الشيء الذي التزم به الهنود واليهود والأمريكان حتى لايتقاتلوا ويبدعوا ويهيمنوا. ..؟
إن مكائد الأعداء لنا ليست سببا في تخلفنا ولكن ضعفنا وتفرقنا هو الذي يعبّد الطريق لسيطرة الأعداء علينا .
يوم سقوط الدولة العباسية مثلا لم يكن هناك شرق ولا غرب كنا نحن الشرق والغرب!
لنا مصلحة كبرى في التوقف عن البحث عن مشجب نعلق عليه خطايانا وأخطاءنا.
6- لدينا خاتمة الرسالات التي منحتنا الرؤية والمنهج وهدتنا إلى سبيل النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة ولكن علينا الإبداع في إيجاد النظم والآليات والوسائل التي تخدم المبادئ وتحولها من عقائد وشعارات إلى أشياء حاضرة ومؤثرة في حياتنا وعلاقاتنا.
قبل هذا علينا أن نكف عن تحويل الوسائل التي أبدعها أسلافنا إلى مقاصد نجمد عليها ونحار في تحقيقها كما حصل في تعاملنا مع مسألة الحكم وإدارة الشأن العام في معظم التفاصيل.
أنا واثق من عظمة هذه الأمة ومن قدرتها على الذهاب إلى الريادة الحضارية لكن هذا يتطلب مناهضة متواصلة لثلاثة أعداء عتاة : الجهل والفقر والاستبداد.
والله المعين والهادي إلى سبيل الرشاد.
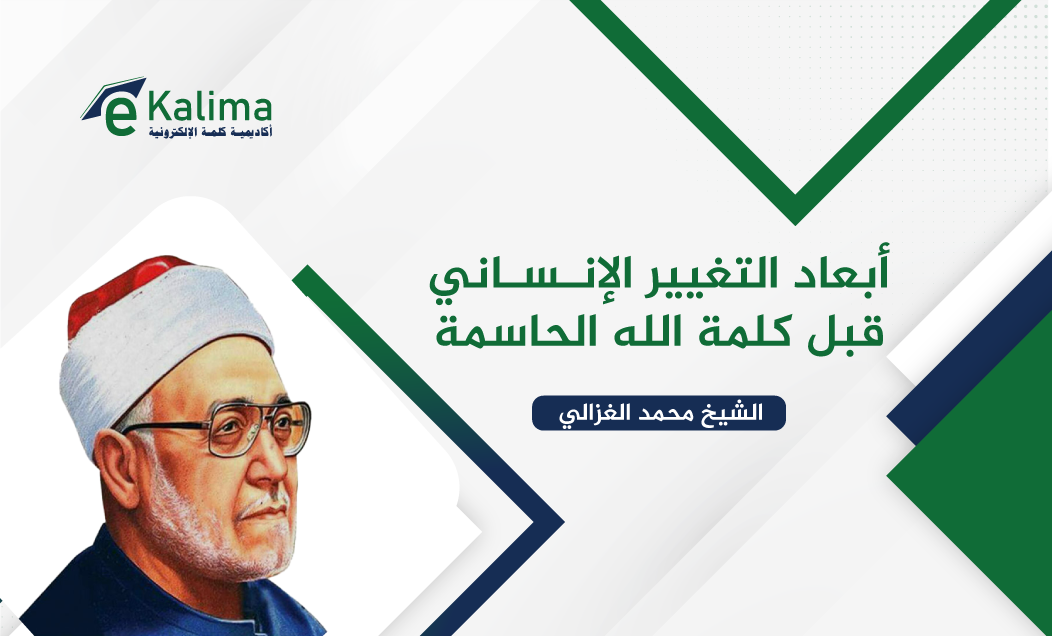
أبعاد التغيير الإنسانى قبل كلمة الله الحاسمة
محمد الغزالي
لا تنجح رسالة أو تزدهر حضارة أو تسبق أمة إلا إذا وقع تغيير جذرى فى كيان هذه الأمة السابقة المتفوقة، أو تلاقت خصائص مادية وأدبية فى مقومات تلك الرسالة الناجحة والحضارة المزدهرة. نعم، فصعود الجماعات أو هبوطها لا يتم وفق حظوظ عمياء أو مصادفات طارئة! بل للمد والجزر علل كامنة إن غابت عن العين المجردة فلن تغيب عن البصائر الحادة والعقول الثاقبة.
[سنن الله تعمل عملها]
وقد تتبعت أسباب التحليق والإسفاف عند من يحلقون ومن يسفون فوجدت سنن الله الكونية تعمل عملها كأنها خصائص المادة وقوانينها الثابتة، ولا تنخرم ولا تتخلف. ويسرنى أن أقدم نموذجا لاطراد هذه الحقيقة من سورة (الأنفال) وهى تخص أسباب النصر لقوم والهزيمة لآخرين. ولكن ـ قبل هذا التقديم ـ أثبت كلمة قالها سائح مسلم فى ديار الأندلس قال: إن الدليل الذى قادنى بين آثار الحمراء، تناول المسلمين بالكلمة الحاسمة، لقد قامت لهم دولة هنا لما كانوا لله خلائف، ثم طردوا من هذه الديار لما أصبحوا على ثراها طوائف. العبارة لاذعة بيد أنها تصور الحق المجرد، يوم قادهم الإيمان قامت لهم دولة ترعى الخير والشرف، وتصدر للآخرين العقائد والقيم، فلما أسلموا زمامهم للشهوات، ومزق وحدتهم الترف وحب الدنيا، لم يبق لوجودهم معنى، فعادوا من حيث جاءوا. ترى هل وعوا ذلك الدرس الفاجع؟ لا أدرى! ولكنى وأنا أتدبر القرآن الكريم وجدت صورة لأبعاد التغير الذى يسبق كلمات الله الحاسمة فى الإعزاز والإذلال، وجدتها وأنا أتلو سورة الأنفال، فأحببت أن أصورها فى هذه العجالة. وفى وسط السورة تلمح قادة الوثنية الجاهلية وهم يودعون الحياة شر وداع، تتناولهم ملائكة الموت باللطمات والصفعات وهم يواجهون جزاءهم: (ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق * ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد).
[أسباب التغيير للأسوأ وللأحسن]
ماذا فعلوا؟ ظلوا أمدا طويلا يكرهون الحق ويؤثرون العناد، ويحيون لأنفسهم فما يرجون لله وقارا، ولا يتخذون عنده مآبا. كانوا فى رخاء لا تشوبه أزمة، وفى أمان لا يعكره قلق، فما شكروا من هذه النعماء قليلا ولا كثيرا، وجاءهم رجل منهم لا ترقى إلى سيرته تهمة فطاردوه فى صلف غريب. والإنسان العادى إذا اشتبهت عليه الأمور طلب من الله أن يهديه إلى الصواب، أما هؤلاء فقد أبغضوا الحق، وأبغضوا النزول على حكمه، وقالوا مكابرين رب الكون: (إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم). ولقى دعاؤهم الأخير بعض الإجابة، فلما التقوا بالمسلمين فى (بدر) حل بهم خزى رهيب، وتبخر السراب الذى كانوا يعيشون فى خداعه فسقطوا بين قتيل وأسير. إنهم ليسوا وحدهم الذين يفسدون فيعاقبون، كان الفراعنة على هذا الغرار، فغشيهم من اليم ما غشيهم: (كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب * ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم). وعند الجملة الأخيرة نقف طويلا لنتساءل: ما أبعاد هذا التغيير وما مداه؟ إن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا ويؤكد بعضه بعضا! فى سورة أخرى يقول جل شأنه: (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم). ويقول بعدما أودى بنعيم (سبأ) وخرب جنانها: (وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل * ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور).
ويقول فى أهل مكة لما حاربوا الرسالة الخاتمة، وقاوموا إمام الأنبياء، ورفضوا إجالة النظر فيما عرض من آيات بينات.. يقول: (وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون). وما يجب إبرازه هو طول المدة التى يستغرقها الاختيار الإلهى، فإن الأقدار طويلة الأنفاس، والصراع بين الحق والباطل لا تكتشف عقباه فى سنة أو سنتين، ولا فى جولة أو جولتين. إنه قد يستوعب السنين والقرون: (وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير). ولما كان عمر الأفراد محدودا، فقد اقتضت حكمة الله أن يهيئ لكل إنسان فرصة كافية يتمكن فيها من معرفة الحق، ويقدر فيها على اعتناقه، وذلك من تمام العدل الإلهى.
إن الناس تحكمهم تقاليد شديدة، ويتوارثون أفكارا يحتاج نقدها ووزنها إلى زمان غير قصير.. بل إن الأهواء التى تصرف البشر لها سلطان محيط، والخلاص منها لا يتم بين عشية وضحاها. وقد تأملت فى ماضى خالد بن الوليد عبقرى الحروب الملهم، وماضى عمرو بن العاص السياسى الداهية، فوجدت كلا الرجلين لم ينشرح صدره للإسلام إلا بعد ما يقرب العشرين سنة. ومن رحمة الله وحكمته أن منحهما هذه الفرصة، وهما مثل لغيرهما من سائر الخلق. وفى سورة الأنفال رأينا المعركة التى قصمت ظهر الوثنية، وقعت بعد خمس عشرة سنة من بدء الرسالة كانت هذه الفترة هى المدة التى حددها القدر الأعلى ليكتشف مصير فريقين من الناس. أولهما: المؤمنون الذين تحملوا العنت وصابروا الليالى الكوالح وهم يساندون الحق ويأملون فى الغد القريب أو فى الدار الآخرة إن فاتهم النصر فى هذه الدنيا. والفريق الثانى: الكفار الذين قاوموا الشعاع المقبل بكل ما لديهم من جبروت، واستماتوا كيما يبقى ليل الوثنية مخيما على جزيرة العرب وكيما تبقى الخرافات تسرح فى المشارق والمغارب.
ويخيل إلى أنه إلى آخر ليلة باتها المشركون قريبا من بدر كانت الفرصة باقية أمامهم ليسلموا ويسلموا.. ولكن المرء عندما يمضى على سيرته، أو عندما يتحرك وفق طبيعته يرتكب الغلطة التى تبت فى عاقبته كلها، أى يفعل ما يسمى بالقشة التى قصمت ظهر البعير، أو القطرة التى فاض بها الإناء. وذلك ما فعله أبو جهل، كان الرجل يستطيع أن يعود بقومه ما دامت القافلة التى خرجوا لإنقاذها قد نجت، بيد أن مشاعر الكبرياء والغرور هاجت فى دمه فقال : لا نعود حتى ننحر الجزور، ونشرب الخمور، وتغنى لنا القيان، ويسمع بنا العرب فلا يزالون يهابونا أبدا.. أى أنه كان حريصا على إذلال الإسلام وأهله فى مهجرهم الجديد. إن هذا القصد النزق هو الذى ذبحه، وقاد قومه معه إلى المأساة! وهذا ما تفسره الآيات من سورة الأنفال التى نزلت لتشرح العدل الإلهى فى مصاب المهزومين: (ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم). وفى أول السورة يزداد الأمر وضوحا، إن القدر الأعلى تدخل على غير ما يود المؤمنون! إنهم كانوا يودون الأوبة إلى المدينة بغنيمة باردة يدعدعون بها حياتهم المرهقة! ولكن الله ـ بعدما أنهى المشركون الفرصة الممنوحة لهم كى يعقلوا ـ قرر إنزال ضربة مهينة بهم: (وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين * ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون). إن الأمم تضيع بعدما تبدد آخر فرصة للنجاة، والأقدار التى تنزل بصعود هذا، أو هبوط ذاك ليست حركات عابثة، إنها أقدار تزن بدقة هائلة مسالك الأفراد والجماعات.
وتتجدد فرصة النجاة، أو إمكانات التوبة مرة أخرى أمام الصناديد الذين وقعوا أسرى! لطالما ضيقوا الخناق على الآخرين وحرموهم الكلمة وحرية المعتقد، وهاهم أولاء أصبحوا فى قيود الهوان والمسكنة لقد قيل لهم: إنكم وحدكم الذين تصنعون مستقبلكم، إن انتويتم خيرا للناس انفتحت أمامكم مجالات رحبة للحركة والعطاء، وإلا فلكم الويل: (يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم * وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم).
[دور التدخل الرباني]
إن الخونة قد يستطيعون الإساءة إلى غيرهم ردحا من الزمان، وقد يتطاولون فى المجتمعات ويحسبون أن الجو قد خلا لهم.. غير أن القضاء الحكيم يتربص بهم إلى حين، ثم يستمكن الوثاق من أعناقهم. وندع المجتمع الكفور يلقى مصيره كما صورته سورة الأنفال، ونلقى نظرة أخرى على المجتمع المؤمن! لقد عاش قبل الهجرة وبعدما يحترم دينه، ويقدم مطالبه على رغائبه، ويحمل فى الحياة شارته ويرفع رايته! وكان خصومه يستكثرون عليه حق الحياة كما يريد، بل كانوا يروعونه فى الحرم الآمن، ويرغمونه على النزوح هنا وهناك.. لقد أنالته الأقدار مكافأة سخية لم تخطر له ببال، فضلا عن أن يرسم لها خطة ويشرف على التنفيذ. أجل، لقد أنالته الأقدار النصر والتمكين والسيادة، وإلى ذلك أشارت الآية الكريمة: (واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون). وهنا نلقى نظرة أشمل على السورة كلها، لنرى أنها فى صدرها رسمت صورة المجتمع المؤمن حقا ثم بثت خلال القصص الواعى وعبره البالغة نداءات شتى للمؤمنين تحدوهم إلى الكمال وكأنها تقول لهم: إن البقاء فى القمة يحتاج إلى مثل الجهد الذى بذر فى بلوغها! فلا قعود ولا ترف. ومن أجل ذلك تضمنت السورة ستة نداءات لا يستغنى عنها سلف ولا خلف، بل لعلنا أحوج الناس إلى فقهها.. أول هذه النداءات وآخرها يقومان على معنى واحد، هما قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار). وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون).
وثم أربعة نداءات أخرى تتضافر على صون الأمة، واستدامة صلاحيتها للرسالة التى تحملها، هى قوله:
(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون).
وقوله: (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم).
وقوله: (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون).
وأخيرا قوله: (يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا).
ذلكم هو الأساس للتغير الشامل الذى يجىء بعده حكم القدر بيننا وبين أعداء الله، وهو أساس لا يختلف مع اختلاف الليل والنهار.
(*) من كتاب علل وأدوية، والعناوين التي بين معقوفتين من عمل المحرر.
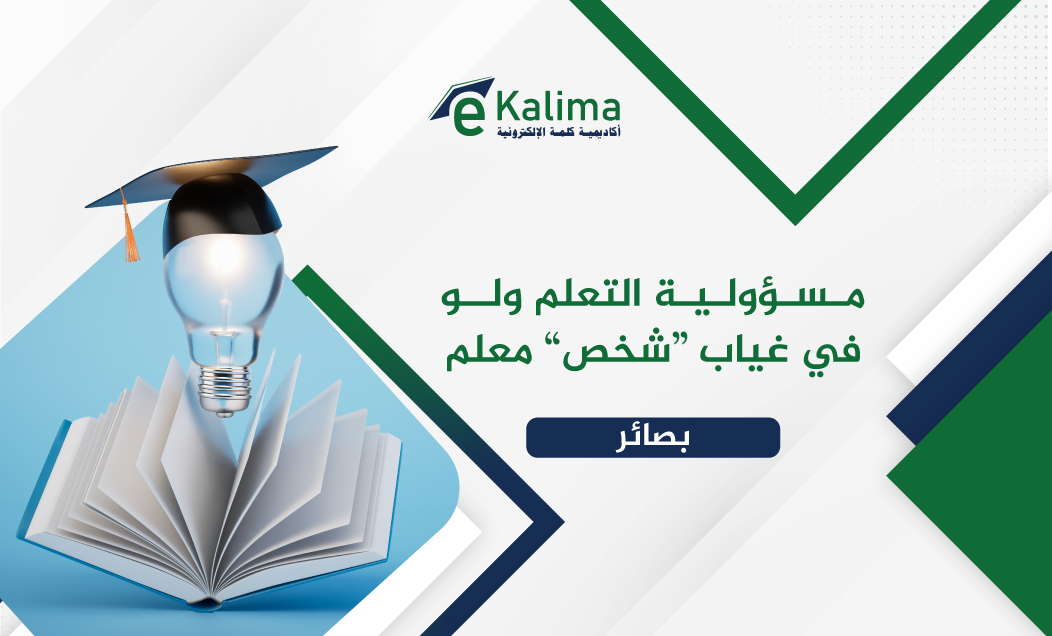
مسؤولية التعلم ولو في غياب “شخص” معلم
بصائر
ربما من أوائل ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن العلاقة بين المعلم والمتعلم، قصيدة شوقي: "قم للمعلم وفّه التبجيلا"، ومعارضة إبراهيم طوقان لها في قصيدته "الشاعر المعلم"
على صراحة الثانية واقعيًا وصدق الأولى في المبدأ؛ فالعلاقة التي تربط المتعلم بالمعلم في عصرنا اليوم لم يعد محورها المعلم كما كان وقتها.
عصر اليوم هو عصر الصناعات: صناعة الذات وصناعة العلم وصناعة المعلم، ومن لا يصنع بيديه يهدر نفسه بيديه!
فقد كان العلم مُلْكًا لمن يُغالي الثمن وهو اليوم لؤلؤ مَكنون لمن يُحسِن التنقيب عنه.
اليوم أمامك كل هذه الامتيازات، من الإنترنت، إلى الوسائط المرئية والمسموعة، إلى وفرة في الكتب لم نشهد لها مثيلًا؛ فالمعرفة لم تكن متاحة من قبل للكل سواسية وبالمجان، كما هي في عصرنا اليوم، ومن ثَم لم يعد التعلم اختيارًا ولا التفوق رفاهية لمن أتيحت له كل تلك الامتيازات، بل صار حتمًا وواجبًا وأمانة، لا بد من الوفاء بها.
يستمر التهافت على الدّوْرات التي يتولى الأهل عبء الإنفاق عليها، في حين أن كل شيء اليوم يمكن تعلمه ذاتيًا
ومع ذلك يستمر التهافت على الدّوْرات و"الكورسات" التي يتولى الأهل عبء الإنفاق عليها، في حين أن كل شيء اليوم - بلا مغالاة - يمكن تعلمه ذاتيًا، لمن أراد أن يفعل؛ فالمواقع والكتب والدورات والشروح الإلكترونية على الإنترنت، ما خَلَّت ولا أَبقَت فرعًا من المعارف إلا ولها فيها نصيب.
خذ مثلا أية لغة أجنبية – بما فيها اللغات الإفريقية والآسيوية – تَجِدْ لها آلاف المواقع، ذاتِ المواد المقروءة والمرئية والمسموعة، لشرحها بإسهاب، والمقبلون على تعلم اللغة العربية، تتوافر أمامهم آلاف المواقع والكتب الإلكترونية، لتعليم اللغة العربية بلغات وسيطة – أشهرها الإنجليزية، ومكتبات العالم كلها صارت مفتحة الأبواب على الإنترنت، والعديد العديد منها مجاني، حتى إن المكتبات العربية الإلكترونية أحرزت تقدمًا ملحوظًا.
والتشكيك المستمر في مصادر الإنترنت وموارده، صار حُجَّة قد وَهَنَت خيوطها؛ فالمصادر الموثوقة في ازدياد، والباحث الإنترنتي – كغيره من الباحثين – يكتسب خبرة في طرائق البحث، وحَدْسًا يُمَكنّه من تمييز الغَثِّ من السَّمين، ولكن الأمر يحتاج لمِران ودأب ومثابرة، شأن أية خبرة أو مهارة يكتسبها المرء في الحياة.
الفوضوية في طلب العلم الحر لن تبني علمًا حقيقًا ولا بنيانًا راسخًا، وإنما شذرات من هنا وهناك لا رابط بينها
ومن طرائف ما قيل لي حين كنت أعدّد فوائد الإنترنت، أن استخدامها كثيرًا ما يُحْوِج المستخدمَ لمعرفة اللغة الإنجليزية؛ وذلك حق.. لأن الإنترنت العربية لا تزال بحاجة للمزيد من التطوير والإمداد المعرفي، فيَحْسُن الاستعانة بلغة أجنبية وأشهرها الإنجليزية، في أمور البحث العلمي بالذات.
ووجه الطرافة في ذلك القول، أن ما تخيله القائل عقبة أمام استعمال الإنترنت، يُمْكِن في الحقيقة التغلب عليه باستعمال الإنترنت، من خلال آلاف المواقع التي تعلم الإنجليزية، من بينها مواقع عربية كذلك! وهكذا تصير العقبة غَلَبة، ويتحول الفشل إلى نجاح، بالجهد الذاتي وسعي الفرد في تطوير نفسه بنفسه.
هذا ولا غنى عن المنهجية في طلب العلم ولو كان الطلب ذاتيًّا، والاسترشاد بخبرات السابقين والاستعانة بموجه ولو عن بعد، والاعتصام بالدعاء وطلب الهداية؛ فالفوضوية في طلب العلم الحر لن تبني علمًا حقيقًا ولا بنيانًا راسخًا، وإنما شذرات من هنا وهناك لا رابط بينها.
وبذلك يظل الإشكال قائمًا وإن اتخذ شكلًا إبداعيًا؛ فإذا كنت مثلًا صاحب قراءات عريضة في أية لغة، ثم لا يمكنك أن تكتب مقالة سليمة اللغة حسنة الصياغة بغير أخطاء، فهذه قراءات غير واعية وغير نافعة بغض النظر عن كون موضوعها نافعًا أم لا، القراءة الواعية الممنهجة ليس بالضرورة ستنتج أديبًا أو شاعرًا، لكنها لا بد أن تثمر علمًا باللغة لفظًا وتعبيرًا، وروحًا وتذوقًا.
المنهجية الواعية في التعلم هي أساس الانتفاع بالعلم، وإلا فالعلم أكبر من أن يحيط به فرد، تمامًا كمن يريد أن يعبر البحر في الاتجاهات الأربعة كلها!
خيرُ ما تتولى من أمورك هو تهذيب نفسك وتطويرها، فاستثمر عمرك تَزدهرْ حياتُك، واستصحب النية الخالصة لله تَنْصلِحْ آخرتُك
يقول د. عبد الوهاب المسيري في كتاب "رحلتي الفكرية": "الرغبة المعلوماتية حينما تنهش إنسانًا فإنها تجعله يقرأ كل شيء حتى يعرف كل شيء، فيتنهي الأمر بالمسكين ألا يعرف أي شيء... المعرفة لا حدود لها والمعلومات بحر يمكن أن يبتلع المرء، ومن هنا لا بد من التوقف عند نقطة ما... فلو قرأت كل ما كتب عن تخصصي لقضيت سحابة أيامي أقرأ وأستوعب من دون أن أنتج شيئا"
ختامًا
رحم الله الشاعر القائل:
ما حكَّ جِلْدَكَ مثل ظُفْرك :: فتَولَّ أنت جميع أمرك
وخيرُ ما تتولى من أمورك هو تهذيب نفسك وتطويرها، فإنك أنفاسٌ معدودة، وكل يومٍ يَمضي، يُدْنِي من الأَجَل، فاستثمر عمرك تَزدهرْ حياتُك، واستصحب النية الخالصة لله تَنْصلِحْ آخرتُك، واللهَ أسألُ أن يحفظك ويسدد خُطاك.

الثقافة الأدبية من مقومات الداعية الناجح
المؤلف : د. وصفي عاشور أبو زيد
مجلة المجتمع
نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، ورسول الإسلام رسول عربي بعث للناس كافة، ومعجزة الإسلام الكبرى وآيته العظمى – وهي القرآن الكريم – معجزة بيانية وأدبية أثرت في مؤيديها ومعارضيها على السواء، بل كان معارضوها لا يستطيعون مقاومة سماعها دون استراق السمع لها والتأثر بها.
ولقد قرر القرآن الكريم هذه الحقيقة في أكثر من موضع، وأكد على أنه نزل عربيا غير ذي عوج، بلسان عربي مبين؛ لتتحقق البشارة والنذارة، وليتحقق التعقل والتفهم والتدبر لآيات الله تعالى، نذكر من ذلك:
قوله تعالى: (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (2)) (يوسف).
وقوله: (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (103)) (النحل).
وقوله جل شأنه: (وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (192) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (195)) (الشعراء).
وقوله: (وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا (113)) (طه).
وقوله تعالى: (وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآَنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (27) قُرْآَنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (28)) (الزمر).
وقوله: (حم (1) تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (2) كِتَابٌ فُصِّلَتْ آَيَاتُهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (3)) (فصلت).
وقوله عز مِنْ قائل: (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (7)) (الشورى).
وقوله جلت قدرته: (حم (1) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (3)) (الزخرف).
وروى البخاري بسنده عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُثْمَانَ أَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنْ يَنْسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ، وَقَالَ لَهُمْ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي عَرَبِيَّةٍ مِنْ عَرَبِيَّةِ الْقُرْآنِ فَاكْتُبُوهَا بِلِسَانِ قُرَيْشٍ، فَإِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ بِلِسَانِهِمْ، فَفَعَلُوا (صحيح البخاري. كتاب . باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب وقول الله تعالى “قرآنا عربيا” “بلسان عربي مبين).
*الثقافة الأدبية مطلوبة للمسلم بله الداعية
لما كان القرآن الكريم هو المصدر الأول للداعية، الذي منه يستمد، وعليه يعول، وإليه يرجع، وبه يستشهد ـ وجب عليه أن يتفقه في التعامل معه، وحسن الاستشهاد به، ويتمرس بأسلوبه وبيانه؛ حتى يتسنى له خدمة الدعوة.
وإذا كان تعلم العربية مطلوبا لكل مسلم كما قرر الإمام الشافعي حين قال: “فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، ويتلو به كتاب الله، وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير، وأمر به من التسبيح والتشهد، وغير ذلك” (الرسالة: 48-49. تحقيق أحمد شاكر. دار الكتب العلمية). فما بالنا بعلماء الإسلام ودعاته؟!.
ومن هنا كان على المشتغلين بالعلم والاجتهاد والفقه والأصول وشؤون الدعوة أن يتضلعوا من علوم اللغة العربية وآدابها: فقهًا في اللغة، ومعرفة بتاريخها، وتعمقًا في لهجاتها، وتأملا في دلالاتها، وعلما ومهارة في نحوها وصرفها، واطلاعًا وحفظًا لشعرها ونثرها بما ينهض بهم لاستيعاب الرسالة الإسلامية، وفهم تعاليمها ومبادئها ومقرراتها ونصوصها كما هي، وما يمكنهم من تبليغ هذه الرسالة كما فهموها في ضوء فهم اللغة العربية الشامل، وهي اللسان الذي نزل به الإسلام.
ولقد قرر الإمام الشافعي، وهو فصيح يحتج بكلامه في اللغة: أنه “لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحدٌ جَهِلَ سَعةَ لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها، ومَن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها، فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة نصيحة للمسلمين، والنصيحة لهم فرض لا ينبغي تركه، وإدراك نافلة خير لا يدعها إلا من سفه نفسه وترك موضع حظه وكان يجمع مع النصيحة لهم قياما بإيضاح حق، وكان القيام بالحق ونصيحة المسلمين من طاعة الله وطاعة الله جامعة للخير” (الرسالة: 50).
فلن يستقيم للمسلم فهم الإسلام إلا بمعرفته بالعربية، ولن يستطيع الداعية أن يبلغ الرسالة ـ فضلا عن فهمها ـ إلا بالاطلاع الشامل على آدابها وأدبها.
*الثقافة الأدبية من محاور النهضة والإصلاح
إن الاهتمام باللغة العربية وآدابها شعرًا ونثرًا كان محط عناية الخلفاء الراشدين، وأئمة التابعين، والعلماء النافعين، وأحد محاور النهضة والإصلاح والتجديد عند دعاة الإسلام ومصلحيه على مر العصور؛ فهاهم الخلفاء الراشدون كان لكل منهم اهتمام بالشعر والأدب، ويروى عن كل منهم شعر، وبخاصة الإمام علي رضي الله عنه، ومن لم يكن منهم أديبًا شاعرا كان يروي الشعر ويحرص على روايته.
بل إن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان له شعراء مثل: حسان بن ثابت، وعبد الله بن رواحة، وكعب بن مالك، وقد كان الشعر على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أحد أسلحة المقاومة والإعلام، حتى قال لحسان رضي الله عنه: “اهجهم وروح القدس معك”.
وكان لرموز الإصلاح والتجديد والنهضة على مر العصور وعي بهذه القضية، التي تعتبر إحدى مرتكزات التجديد والنهضة، حتى إن الذاكرة المسلمة لا تكاد تذكر إلا من كان لهم صلة واهتمام وعناية بهذه القضية؛ ذلك، أن العلماء والدعاة والمجددين لن يقوموا بدورهم دون أن يرتكزوا على هذا المحور الهام.. فبعد الخلفاء الراشدين والصحابة جاء علماء ومجددون نفع الله بهم الأمة، وكان من مناطات هذا النفع ارتكازهم على هذه الركيزة الأساسية، ومنهم: فقهاء التابعين، وأئمة التزكية والسلوك، والأئمة الأربعة وبخاصة الإمام الشافعي، والإمام ابن تيمية ومدرسته، والعز بن عبد السلام، والقرافي، والشاطبي، والشوكاني، وزاهد الكوثري، ومحمد عبده، ورشيد رضا، ومحمد دراز، والطاهر بن عاشور، والسعدي، ومحمود شاكر، والغزالي، وعلي الطنطاوي، والقرضاوي، والشعراوي، وغيرهم.
*العناية بالثقافة الأدبية لازمة للبلاغ
إن النفس البشرية قد تتأثر بالبيان والبلاغة والشعر والنثر بما لا تتأثر معه بغيره من الأساليب؛ ولذلك كان من البيان سحر يسحر النفوس، ويبهج الأرواح، ويقنع العقول، ويمتع الوجدان، وقد روى البخاري بسنده عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَدِمَ رَجُلَانِ مِنْ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِنَّ مِنْ الْبَيَانِ لَسِحْرًا أَوْ إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ” (صحيح البخاري: كتاب . باب إن من البيان سحرا).
ولهذا يقول أديب العربية والإسلام مصطفى صادق الرافعي عن شعور النفس بجمال الأدب والبيان: “فنيةُ النفس الشاعرة تأبى إلا زيادة معانيها، فتصنع ألفاظها صناعة توليها من القوة ما ينفذ إلى النفس ويضاعف إحساسها، فمن ثم لا تكون الزيادة في صور الكلام وتقليب ألفاظه وترداد معانيه إلا تهيئة الزيادة في شعور النفس” (وحي القلم: 3/ 213).
وما ينبغي لداعية أن يسلك سيبل الدعوة دون أن يكون له أوفى الحظ وأفر النصيب من هذه الثقافة، يقول الداعية الكبير محمد أحمد الراشد: “وإني لأعجب من دعاة الإسلام الذين أراهم اليوم، كيف يجرؤ أحدهم على إطالة العنق في المجالس، والنشر في الصحف، قبل أن يجمع شيئا من البيان جمعه الطبري في تأويل آي القرآن؟ وكيف يسرع داعية إلى ذلك وهو لم يكثر من مطالعة كتب الأدب العربي القديم، ولم يعكف مع الجاحظ وأبي حيان، أو ابن قتيبة وأديبي أصبهان؟ وأعجب أكثر من هذا لداعية أثير حماسه لهذه العلوم والآداب فيقول: ليس لي وقت، كأنه غير مطالب بإتعاب نفسه تعبا مضاعفا، ولا شرع له السهر!” (نحو المعالي: 94. مؤسسة الرسالة).
إذن فالعلم بالعربية أحد المحاور اللازمة للبلاغ وحسن خدمة الإسلام بالإضافة إلى محاور في علوم أخرى؛ ولهذا يقول الشيخ محمد الغزالي: “إن الداعية ليس من الضروري أن يكون راسخ القدم في علوم السنة، وليس من الضروري أن يكون فقيها كأبي حنيفة ومالك وابن حنبل، إنما المهم أن يكون عنده قدر من الصحة العقلية وعلم بأوليات الفقه والسنة وسور القرآن وأوليات اللغة العربية بحيث يجعله كلُّ هذا يحسن خدمة الإسلام والدعوة” (مقالات الشيخ الغزالي: 3/159).
*الجهل باللغة والأدب مفسد للدعوة
وفي المقابل، فإن الجهل بالعربية وآدابها لن يؤدي معه الداعية رسالته، ولن يبلغ دعوته، بل إن الشيخ عبد العزيز بن باز قرر أن عدم العناية باللغة العربية يترتب عليه مفاسد كبيرة في مجال الدعوة (مجموع فتاوى ابن باز: 2/342).
وذلك أنه بذلك يغير المعاني، ويفسد الأذواق، وينفر الأسماع، فحسبك أن تجلس إلى خطيب أو داعية يتحدث وهو يلحن في اللغة أو يخطئ في النصوص الشرعية من هذه الناحية، فيكفيك من شر سماعه.
يقول شيخنا د. يوسف القرضاوي: “وانظر كم يقشعر جلدك، ويضطرب قلبك، ويتأذى سمعك، حين تسمع داعية يقول: التُّبْعة، وهو يريد التَّبِعة، ويذكر الأُهُبَّة، وهو يريد الأُهْبَة.. وآخر ينصب المرفوع، ويرفع المنصوب، ولا يفرق بين فاعل ومفعول به، ولا يبالي بإضافة ولا حرف جر” (ثقافة الداعية: 98. مكتبة وهبة. الطبعة العاشرة. 1416هـ/ 1996م).
بل إن اللحن فضلا عن إفساده للمعنى قد يؤدي إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال، يقول شيخنا: “وكثيرا ما يؤدي اللحن إلى إفساد المعنى وإخراجه إلى ما يناقض الشرع والعقل، وشر ما يكون ذلك إذا كان اللحن في كتاب الله، كذلك الإمام الذي صلى أعرابي خلفه، فسمعه يقرأ: “ولا تَنكحوا المشركين حتى يؤمنوا” قال: ولا إن آمنوا أيضا لن نَنكحهم! فقيل له: إنه يلحن، وليس هكذا يُقرأ. فقال: أخِّروه قبحه الله.. لا تجعلوه إماما فإنه يحل ما حرم الله” (ثقافة الداعية: 98).
إن الداعية الذي لا يستقيم لسانه على قواعد العربية ويطالع آدابها لا يؤتمن على فهم الإسلام؛ فضلا عن أن يقوم بمهمة البلاغ؛ لأن القرآن معجزة بيانية أدبية، والسنة النبوية عربية، وما لم يتفقه الداعية بالوعاء الذي احتوى كلام الوحي فلا يجوز له أن يشتغل بالدعوة؛ حتى لا يفسد الأذواق، ويقلب المعاني، ويحل الحرام، ويحرم الحلال.
